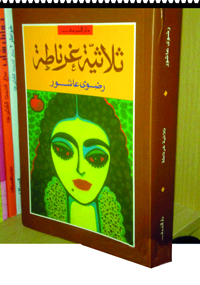مأساة ضياع الأوطان تلوّن عوالم الروايتين
رضوى عاشور.. بين مريمة «غرناطة» ورُقيَّـة«الطنطورية»
سرد حارّ من القلب، وحسّ ملحمي، ووجع تتوارثه أجيال، وحسرة تاريخ وجغرافيا.. ملامح تلّون روايتَي «ثلاثية غرناطة»، و«الطنطورية» للدكتورة رضوى عاشور، إذ يعد العملان محطتين بارزتين في مسيرة صاحبة «أطياف» و«سراج».
وربما تعد محاولة الربط بين الروايتين تعسفاً قرائياً، وتأويلاً قد لا يراه البعض موفقاً، لكن من يطالع «غرناطة»، و«الطنطورية» معاً، يجد خيطاً ممتداً بين العملين، يقوى أحياناً، ويضعف أخرى، ولا يعني هذا أن المبدعة المصرية تكرّر ذاتها، بل يعني أن مأساة ضياع الأوطان واحدة، فمرارات مريمة «غرناطة» تتشابه مع آلام رقية «الطنطورية»، ومطرودي حيّ البيازين في غرناطة الذين حلموا بالعودة الى ديارهم، لا يختلفون كثيرا عن أبناء قرية الطنطورة الفلسطينية الذين حسبوا أن أزمة الغربة لن تطول، وأن «اللاجئ» لقب مؤقت، ستمحوه العودة، يشهد على ذلك مفاتيح معلّقة في الرقاب وعلى جدران المخيمات، وذاكرات تحتفظ بملامح من رحلوا، وكذلك بأشجار ومعالم قرى بعيدة، لم يعد لها اسم على خريطة مغتصبة.
تبرز المرأة في روايتَي رضوى عاشور في عين العاصفة، فتتشارك المأساة مع الرجل، وتتحمل أحزاناً بلا حصر، وتأخذ حظها الوافر منها، تماماً مثل شريكها، بل وتحاول أن تعدل «الحال المائل» حين يغيب السند، لأسباب مختلفة، فثمة شخصيات نسائية غنية بالتفاصيل، صاحبات «أيادٍ خضراء»، ينبتن النعمة حيث حللن، وكان لهن الدور الأبرز في مسار الأحداث، والأخذ بزمام المبادرة في «ثلاثية غرناطة»، و«الطنطورية»، وليس الاكتفاء بأدوار «الولايا» المتفرجات على الأحداث، والساكبات للدموع فحسب. وفوق ذلك تظهر المرأة وكأنها الحارس الأمين على الذاكرة، خزانة الخرائط المفقودة، وكتابها الحي المسؤول عن توريثها لأجيال ولدت في الشتات.
مشهد أول
|
عائلة مبدعة ولدت رضوى عاشور في القاهرة عام 1946، وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1967. حصلت على الماجستير في الأدب المقارن عام 1972 من الجامعة نفسها، وحصلت على الدكتوراه في الأدب الإفريقي الأميركي من جامعة ماساشوستس بالولايات المتحـدة عـام 1975. تزوجت رضوى عاشور الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، ولهما ولد وحيد هو الشاعر تميم البرغوثي الذي اكتمل به عقد العائلة المبدعة. تنوع نتاج الدكتورة رضوى عاشور بين الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي والثقافي، وترجمت بعض رواياتها وقصصها القصيرة إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والإندونيسية. ومن رواياتها «الرحلة»، و«حجر دافئ»، و«خديجة وسوسن»، و«سراج»، و«أطياف»، و«فرج». ومن مجموعاتها القصصية «رأيت النخل». ولها عدد من الدراسات النقدية، منها «الطريق إلى الخيمة الأخرى: دراسة في أعمال غسان كنفاني»، و«الحداثة الممكنة: الشدياق والساق على الساق: الرواية الأولى في الأدب العربي الحديث». وحازت الدكتورة رضوى العديد من الجوائز والتكريمات، إذ فاز الجزء الأول من «ثلاثية غرناطة» بجائزة أفضل كتاب لعام 1994 من معرض القاهرة للكتاب، ونالت جائزة قسطنطين كفافيس الدولية للأدب عام 2007 من اليونان، وجائزة سلطان العويس الإماراتية في 2011، وألقت كلمة المكرمين في الحفل الذي أقيم في دبي. |
في «الطنطورية» الصادرة عن دار الشروق المصرية عام 2010 في 463 صفحة، تتحكم في إيقاع السرد ومسارات الأحداث بطلة الحكاية، رقية، فتتماس سيرتها مع فصول من المأساة، لتستحيل التغريبة الفلسطينية الى لحم ودم ومشاعر، يوميات حياة نابضة بالمقاومة والإرادة ومواصلة الحياة على الرغم من الخسارات الفاجعة، ومشاهد دماء الأب والأخوين المقتولين بأيدي الصهاينة.
البحار العديدة التي حلت عليها رقية، في عواصم ومدن مختلفة، لم تنسها ذاك البحر الشاهق الزرقة في قريتها الطنطورة التي هجّرت منها مع أمها، وهي طفلة، ويد مجندة إسرائيلية امتدت لتسرق بالقوة «الحلق» من أذني رقية، ما أسال دم الصغيرة، وأشركها مبكراً في دراما حياتية من نوع خاص، ستتوالى فصولها على مدار سنوات وسنوات بعد ذلك.
تقول رقية، راويةً بعض ما حصل في مشهد التهجير الأول: «وصلنا الى صيدا في أول شهر شباط من العام التالي، وحين لقينا عمي وخالتي كنت أرتدي الأثواب الثلاثة، ثوباً على ثوب، وعليها السترة الصوفية التي اشترتها لي أمي من إربد. وكان أول ما نطقت به من الكلام منذ غادرنا بلدنا هو ما قلته لعمي همساً: أبي وأخواي الاثنان قتلوا. رأيتهم بعيني على الكوم. كانوا بين مائة أو ربما مائتي قتيل، ولكنهم كانوا على طرف الكوم، رأيتهم. ستقول لك أمي إن الصادق وحسن ذهبا الى مصر، وإن أبي في الأسر. أنا رأيتهم غارقين في دمهم على الكوم».
هنا تعكس رقية وعياً مبكراً، تعلن توديعها لسنوات اللهو على شاطئ الطنطورة، تركتها في ليلة الدم والدموع، واللحظة الفارقة التي حملت فيها رقية الطفلة، صبيا آخر (عبد) حل هو وعائلته لاجئين عليهم، وحين بكى الصبي عطشاً، تجاسرت رقية وطلبت من المجندة الإسرائيلية ماء للصغير، لكنها لم تنله، وكان الرد هو سرقة قرطيها.
تبدع صاحبة «الطنطورة» رضوى عاشور في رسم تفاصيل تلك المشاهد شديدة الوقع، تلونها بالوجع، وكأنها كانت أحد شهود تلك المأساة، إذ تتبع خطوات من ساروا في دروب شائكة، من سقطوا في الصحاري والبحار، ومن لم يتحملوا إهمال المخيمات، فماتوا وهم في عمر الرضاعة، وتنثر بعفوية فنية مشاهد أمهات رافضات للاعتراف باستشهاد أحبتهن، عشن على أمل أن يعثرن على الغائبين في يوم يأتي الموت قبله.
محطات
تتعدد محطات رقية وعائلتها، تتداخل الأزمنة والأمكنة، رقية الطفلة مع رقية الشابة والزوجة والجدة، فالراوية تحفر في منجم ذهبي حافل بعروق الحكايات، تسرد من هنا وهناك، تتجاور اليوميات في الطنطورة مع فصول من الحياة في صيدا وبيروت وأبوظبي والإسكندرية وغيرها من المحطات التي حلت فيها رقية، وكذلك عائلتها التي تشعبت ومدت جذورها في أمكنة عدة على خريطة العالم.
كما عادتها، تبتعد رضوى عاشور في غَزْل «الطنطورية»، على الخيوط المتعارف عليها، المتداولة كثيراً في عرض «التغريبة الفلسطينية»، إذ ثمة حياة بكل ما تعنيه لم تدون بعد: قوة وضعف، بشر يتسامون وفي لحظات يسقطون، يبوحون بضعفهم الإنساني، وحاجتهم الى العيش مثل «بقية خلق الله». ووجدت الدكتورة رضوى ضالتها في التفاصيل الصغيرة، والتاريخ غير الرسمي، حيث حكايات نساء المخيمات، ووقع الأحداث الكبيرة على هؤلاء، كيف تعاملن مع الثورات والانتفاضات، وكيف تحملن رؤية دماء الأزواج والأبناء، وكيف صلبن عودهن، وعدن الى الحياة، يربين ما تبقى من «العيال»، يكبّرن الصغير، ويروين له ما ينتظره في يوم قد لا يكون بعيداً.
«الثلاثية»
في «ثلاثية غرناطة» تبرز شخصية مريمة، التي يوجد قسم خاص لها، معنون باسمها، إذ إن «الثلاثية»، مقسمة إلى أجزاء: غرناطة، ومريمة، والرحيل. وعلى الرغم من أن مريمة حاضرة من القسم الأول، إلا أنها تكون عماد الحكاية في الجزء الثاني. تعيش مريمة بعد الزواج، بلا مواقف بارزة، تتعلم القراءة والكتابة، وتنجب فتاتها الأولى، ولم تعلن مريمة عن ذاتها الا في مشهد وحيد، فبعد أن صدرت الأوامر بتخيير العرب بين التنصير القسري أو الرحيل عن غرناطة، وبينما أهل بيت أبي جعفر في حيرة من أمرهم، برز الحل على لسان مريمة: «لا نرحل، الله أعلم بما في القلوب، والقلب لا يسكنه الا جسده، أعرف نفسي مريمة وهذه ابنتي رقية، فهل يغير من الأمر كثيراً أن يحمّلني حكام البلد ورقة تشهد أن اسمي ماريا وأن اسمها أنَا. لن أرحل لأن اللسان لا ينكر لغته ولا الوجه ملامحه. تطلعوا إليها في دهشة، فمن أين أتت مريمة الصغيرة بهذه الحكمة؟ وكأنها طاقة أشرعتها فتدفق الضوء جلاء في الحجرة المظلمة، قرروا البقاء». اتسمت مريمة بصفات أخرى، وصارت صاحبة حيل وطرائف يتداولها الجميع: إذ «اشتهرت بين الجيران ونساء الحي بمفـاجآتها المدهشة، يسعفها عقلها بحسن التصرف السريع الذي يحول مرارة حكم القوي على الضعيف الى ضحكات عفية ساعـة تنقلب الآية فيصبح القوي ضعيفاً والضعيف قادراً ومزهواً».
منبعاً للحكايات تظهر مريمة بعد ذلك، موكلة هي بإلهاء الصغار، والتسرية عن نفوسهم بالقصص، تفعل ذلك مع عائشة ابنة سليمة، خصوصاً في اللحظات نفسها التي تحرق فيها الأم، وكذلك للحفيد علي الذي بقي معها، بعد زواج بناتها الخمس بعيداً عنها.
وتحتشد يوميات مريمة بتفاصيل قد تبدو بسيطة، لكنها تظهر قيمة المرأة ودورها، فمريمة تصنع الكعك وتبيعه في السوق، وتستقبل نعيم العائد بعد غيبة طويلة، وترعى البستان الموجود بالدار، وهي المؤتمنة على الأسرار، حتى إن صندوق عرسها هو المكان الذي حفظت فيه مخطوطات الجد أبي جعفر النادرة، ودفن في منزل خاص.
أسئلة النهايات
كما عادة الكثير من شخصيات رواية «ثلاثية غرناطة»، يبدو مشهدهن الأخير حافلاً بالضعف، ومحتشداً بالأسئلة، يلخص مسيرة الحياة، ولا يجد بين فصولها سوى ظلال المأساة المطبوعة على جبين معظم شخصيات الرواية، فحتى مريمة قبل الموت تقول: «أنا مريمة ابنة أبي إبراهيم منشد سيرة نبيك ومصطفاك وصحابته الأكرمين، ولدت يوم كان القشتاليون على أبواب غرناطة يحكمون الطرق عليها، والناس جوع، والزاد شحيح، ولكن أبي كان رجلاً صالحاً، لم يقل: هذه الوليدة تحمل لي نحساً، ضمّني وأنشأني في ظله الضافي. ولما دخلت دار أبي جعفر فرض القشتاليون على العباد تغيير دينهم، فلم تقل أم جعفر دخلت علينا العروس والمصائب في أذيالها. حملت وهناً على وهن كباقي النساء، وربيت الصغار وكبرتهم. ما سرقت يوماً، ما خنت أمانة، ما كذبت قاصدة شراً بأحد من العباد، فلماذا تلوح لي بنصرة في المنام أتعلق بها وتطلق الأمل من صدري ليحلق عالياً، ثم تسقطه فأعيش بدلاً من الحسرة الواحدة حسرتين؟!». وتكون نهاية مريمة بعدما صدر قرار ترحيل جميع العرب من غرناطة، ودّعت مريمة المكان بالدموع، وما لبثت أن ماتت خلال الترحيل، ودفنها الحفيد (علي) في العراء. واللافت أن مصائر الشخصيات في رواية «ثلاثية غرناطة» تستحق التوقف معها طويلاً، فمعظم أبطال الحكاية يصلون إلى خط النهايات وهم على حافة الانهيار، يصارعون هواجس وشكوكاً صاخبة، يشعرون بأنه لا يوجد يقين، وأن رحلة العمر كانت عبثية، وأن انتظاراتهم الطويلة للنجدة كانت بلا طائل، فنهايات أبطال «ثلاثية غرناطة» تتشابه مع مأساة العرب في الأندلس، وما تعرضوا له من تعذيب وقهر وغربة، في أيامهم الأخيرة، ما يعتبر مبرراً، على الأقل فنياً، لتحمل اضطراب الشخصيات وشكاياتها وأساها الشديد.
ولم تهتم الكاتبة رضوى عاشور في «ثلاثية غرناطة» سوى بالشخصيات المنسية، إذ لم تعنها الأسماء الكبرى، في تلك المرحلة الزمنية التي دارت فيها أحداث الرواية، إذ لم تستعن بأسماء تاريخية مشهورة، كان لها دور في تلك الفترة، وحتى حينما يأتي ذكر بعضها، يكون على ألسنة أبطال العمل المتخيَّلين، بلا أي تفاصيل تبرزهم، وكشفت الدكتورة رضوى عاشور في كتابها «صيادو الذاكرة» أنها تعمدت ذلك، موضحة «لم يكن شاغلي الكبراء أو الأمراء والبارز من الشخصيات التي سجل التاريخ حكايتها بل شغلني «العاديون» من البشر: رجال ونساء وراقون ونساجون ومعالجون بالأعشاب وعاملون في الحمامات والأسواق وإنتاج الأطفال في البيوت، بشر لم يتخذوا قرارات بحرب أو سلام، وإن وقعت عليهم مقصلة زمانهم في الحرب والسلام. انهمكت في كتابة انتاجهم لحياتهم اليومية، التفاصيل الصغيرة لعلاقتهم بالمكان والزمان وبعضهم البعض وعلاقتهم بالسماء (سماء تهتهز فوق رؤوسهم مع اهتزاز الأرض تحت أقدامهم، فيرفعونها من جديد). احتلت المرأة في أدوارها المعتادة، وأدوار غير مألوفة، مكاناً في النص. باختصار سعيت إلى قلب الهامش إلى متن ودفع المتن المتسلط إلى الزاوية، وحاولت استنفاذ حكاية بشر لم يلتفت لهم التاريخ العربي والكتابة الأدبية».
![]() تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news